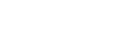كتب جوزيف مسعد في ميدل إيست آي أن إعلان بريطانيا وكندا وأستراليا، باستثناء الولايات المتحدة، اعترافها بما سُمّي "دولة فلسطين" لم يكن خطوة لإنصاف الشعب الفلسطيني، بل مكافأة لسلطة محمود عباس، التي يصفها الكاتب بأنها غير منتخبة وتعمل كوكيل للاحتلال الإسرائيلي. يرى مسعد أن هذا الاعتراف يواصل نهجًا استعماريًا بدأ منذ الاحتلال البريطاني لفلسطين عام 1917، يقوم على شرعنة وكلاء محليين وتهميش القوى الشعبية التي تمثل الفلسطينيين حقًا.
يستعرض التقرير أن بريطانيا منذ بدايات انتدابها رفضت الاعتراف بالمؤسسات الوطنية الفلسطينية، رغم ظهور أكثر من أربعين تنظيمًا سياسيًا بين 1918 و1920 طالب بالاستقلال ووحدة فلسطين ضمن سورية الكبرى. في المقابل، اختارت لندن دائمًا التعامل مع شخصيات أو هيئات متعاونة، ووضعت شرط القبول بالمشروع الصهيوني كمدخل وحيد للاعتراف بأي قيادة فلسطينية.
يشير مسعد إلى أن أبرز هذه التنظيمات كانت "الجمعيات الإسلامية المسيحية"، التي تشكلت في يافا عام 1918 ودعت للوحدة الوطنية ومقاومة الاستعمار البريطاني والصهيونية. لكنها اصطدمت برفض بريطاني مطلق، إذ حُظر انعقاد مؤتمراتها أحيانًا، وقُيدت تحركاتها، فيما سمحت لندن لأطر موازية موالية بأن تتصدر المشهد. ويصف الكاتب هذا النهج بأنه استراتيجية استعمارية متكررة عالميًا: صناعة نخب محلية متعاونة لإدارة الشعوب بدلًا من الاعتراف بقياداتها الشرعية.
يوضح التقرير أن هذه السياسة امتدت إلى العقود اللاحقة. فحين تشكل "المؤتمر العربي الفلسطيني" وهيئة "اللجنة التنفيذية العربية" في عشرينيات القرن الماضي، رفض المندوب السامي البريطاني الاعتراف بها. حتى عندما زار وزير المستعمرات ونستون تشرشل فلسطين عام 1921، أعلن صراحة أن الحكم البريطاني سيستمر أجيالًا، رافضًا أي مطلب بالاستقلال أو بوقف المشروع الصهيوني.
يؤكد مسعد أن القوى الاستعمارية اعتمدت دائمًا على "شروط الاعتراف": قبول الفلسطينيين بالمشروع الصهيوني أولًا. لذلك وُوجهت محاولات الفلسطينيين لانتزاع شرعية دولية بالفشل، من تقرير لجنة "كينغ-كرين" الأمريكية عام 1919 إلى مؤتمرات عصبة الأمم. بل وصل الأمر إلى تأسيس أحزاب محلية بدعم مالي صهيوني، مثل "الحزب الزراعي" و"الجمعية الإسلامية الوطنية"، لتفتيت الحركة الوطنية وخلق قوى موازية موالية.
ويستشهد الكاتب بتاريخ لاحق، إذ رفض الغرب الاعتراف بحكومة عموم فلسطين في غزة بعد نكبة 1948، بينما دعم ضم الأردن للضفة الغربية. وعندما برزت منظمة التحرير الفلسطينية كالممثل الشرعي للشعب منذ ستينيات القرن الماضي، رفضت واشنطن وحلفاؤها الاعتراف بها إلا بعد توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، حين تخلت المنظمة عن دورها التحرري وقبلت الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود على أرض فلسطين التاريخية.
يرى مسعد أن هذا التحول جعل المنظمة نسخة حديثة من "الأحزاب العميلة" التي أنشأها الاستعمار سابقًا، إذ تحولت من أداة مقاومة إلى ذراع متعاونة مع الاحتلال. ومع بروز حركة حماس كقوة سياسية بعد فوزها في انتخابات 2006، رفض الغرب مرة أخرى الاعتراف بخيار الشعب، ودعم انقلابًا لإقصائها من الضفة الغربية. بالنسبة للكاتب، يبرهن هذا النمط أن القوى الغربية لا تعترف إلا بمن يضمن استمرار السيطرة الصهيونية، بينما تهمّش كل من يعبّر عن الإرادة الشعبية الفلسطينية.
يتناول التقرير واقع السلطة الفلسطينية اليوم، حيث تعمل أجهزتها الأمنية كأداة مباشرة للاحتلال في قمع المقاومة، وتغرق في فضائح فساد وصراعات داخلية. ويشير مسعد إلى أن الاعتراف الغربي الأخير بالدولة الفلسطينية لم يأتِ استجابةً لمطالب التحرر، بل مكافأة للسلطة على ولائها وقيامها بدور "المنفذ المحلي" لسياسات إسرائيل.
ويخلص الكاتب إلى أن الهدف من هذا الاعتراف ليس تمكين الفلسطينيين من حق تقرير المصير، بل ترسيخ دولة استعمارية يهودية في فلسطين التاريخية، مع توفير غطاء شرعي لسلطة تفتقد أي تمثيل شعبي. وهكذا، فإن ما بدأته بريطانيا قبل قرن يتواصل اليوم: الاعتراف لا يُمنح إلا للمتعاونين، بينما تُقصى القوى التي تجسد طموحات الشعب الفلسطيني في الحرية والتحرير.
الأحد 29 رجب 1447 هـ - 18 يناير 2026
أخبار النافذة
نتنياهو يخوض معركة فاشلة
اللجنة الوطنية لإدارة غزة
الدكتور الصلابي والمصالحة في ليبيا و"خرافة أم بسيسي"
دراسة أكاديمية: الاستقطاب الإعلامي في تغطية سدّ النهضة
بعد تشكيل التحالف المصري – السعودي.. وزير صومالي سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال جاء بنتائج عكسية
ديون مصر على الطاولة من جديد.. بين «المقايضة الكبرى» وغياب إستراتيجية واضحة لإدارة الدين العام
الجيش الإسرائيلي يزعم: اعتراض طائرتين مسيرتين حاولتا تهريب أسلحة عبر الحدود المصرية
وقفة احتجاجية لعمال مطاحن مصر الوسطى بالمنيا.. أرباح بالملايين ورواتب لا تكفي الحياة